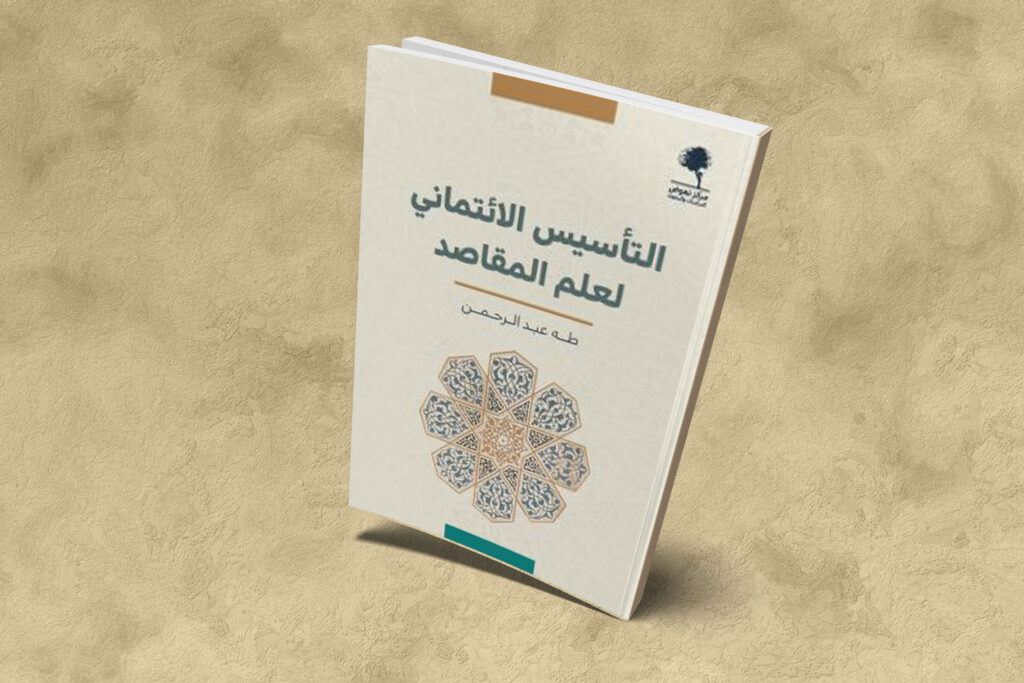عبد السلام المنصوري
1/ عرف العَصرُ الحديث عودةً قوية ولافتة إلى قضيّة “مقاصِدِ الشريعة”، وغالبا ما ارتبطت هذه العودةُ برفع شعار “تجديد علم أصول الفقه”، في مُحاولةٍ لمدّ المدونة الفقهية بأسبابِ الحيويّة والبقاء، ورفدِها بأدوات التجديد، خاصّة مع الإحراجات الفلسفية والأخلاقيّة الكثيرة التي طرحها العصرُ الحديثُ، (والإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان) على مُدوّنةِ الفقهِ التقليدي. ولم تكن هذه العودَةُ مُقتصرةً على تيار التجديد الدينيّ، الذي تمترسَ وراء قلعةِ المقاصد، في مُواجهةِ جيش التقليد، الذي أصرّ على مُواجَهة مشكلات العصر بالأسلحة القديمة ذاتها. بل إنّ التيّارَ العلمانيّ والحداثي كان له نصيبٌ من هذه العودة ومن تلكمُ الدّعوة، في مُحاولةٍ لتجاوز تفريعات الفقه التقليدي، عبر الاحتكام إلى قواعدَ عامّة، وكليات تشريعية، (غالبا ما تتميّزُ بالضبابية والهلامية)، من قبيل “المصلحة” و”المنفعة” و”القيمة” و”الكرامة الوطنية”، وهو ما نجده بشكل واضح في كتابِ حسن حنفي “من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه”. وكان لابد في ظلّ هذا التجاذب التأويليّ لنظريّةِ المقاصدِ، أن يحتدمَ الصّراعُ على تبنّي “الشاطبي” (باعتباره ذروة الفكر المقاصدي) ومنحه بطاقة هويّة جديدة في عالم لا ينتمي إليه.
2/ يعود الفضلُ في بعثِ نظريّةِ المقاصد في العصر الحديث، إلى عالمَيْن جليلين، ورمزَيْن من رموز الإصلاح والتجديد في الأزمنةِ الحديثة، أولهما خرّيجُ الزيتونة بتونس، وهو “الطاهر بن عاشور” في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية”. وثانيهما خرّيج جامع القرويين بالمغرب، وهو “علال الفاسي” في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها”. وإذا كان الأول له أسبقيّةٌ زمنيّةٌ (بحكم الفارق في السن بينهما). فإن محاولة علال الفاسي هي الأكثر تجديدا ونضجا، كما يرى أغلبُ الباحثين في المقاصد (ومنهم طه عبد الرحمان في كتابه هذا). وقلما نجدُ كتابا حديثا في المقاصد (على كثرة الأبحاث ووفرتها) لا يشتبكُ مع هذين المشروعَيْن، سواء من الاتجاهات الإسلامية، أم من التيارات العلمانيّة. من مظاهر هذا الاشتباك؛ تعدُّدُ القراءات النقديّةِ في مشروع كل من “ابن عاشور” و”الفاسي”. ومن مظاهره أيضا؛ إعادةُ قراءةِ “الشاطبي” نفسِه بمناهجَ حديثة وحداثية، ترومُ تجاوز قراءة هذين العلمَيْن الكبيرين.
3/ بدأت القصّةُ في الخطابِ الحداثي مع المُفكّر المغربي البارز محمد عابد الجابري، الذي خصّص فصلا قصيرا من كتابه “بنية العقل العربي”، للحديث عن الشاطبي. وتقومُ أطروحةُ الجابري على اعتبار الشاطبي “دشن قطيعة إبستمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكل الأصوليين الذين جاؤوا بعده” (البنية ص540)، وطبقا لنظرية العقول الثلاثة الشهيرة عند الجابري: البيان والبرهان والعرفان. فإن الشاطبي بمشروعه المقاصدي تجاوز مشروع “البيان” الذي وضعه الشافعي، ليستدمجَ علم أصول الفقه في “البرهان” عبر تبنّيهِ لفكرةِ المقاصد القائمة على الاستقراء، وللقياس البُرهاني (المقدمات المنطقية) بديلا عن القياس البياني (الأصل بالفرع). والنتيجة أن الشاطبيَّ حسب قراءة الجابري، هو جزء من مشروعِ المدرسةِ المغربيّةِ البرهانية، التي تجاوزت “أزمةَ الأسس” في المشرق بعد تصالح البيان مع العرفان على يد الغزالي، أو تصالح البرهان مع العرفان على يد ابن سينا.
وبالرغم من أن الباحث والمفكر عبد المجيد الصغير، في دراسته عن “الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام”، لم ينجرف وراء فكرة “القطيعة”، وتحدّثَ عن مشروع الشاطبي باعتباره “يشكّلُ في عمقه نوعا من الاستمرارية” (الفكر الأصولي، ص443)، وبالرغم من ربطهِ المَتين بين الشاطبي والأصوليين قبله، الذي تكلموا في المقاصد؛ كالقرافي والجويني والغزالي والعز بن عبد السلام.. الخ. إلا أنه تحدث بمفردات قريبة من الجابري، حين تبنّى فكرة “بُرهانيّة الشاطبي” بدل “بيانيّتِه”، وجعل عنوان الفصل السادس: “المقاصد الشرعية: من مشروع البيان إلى مشروع البرهان”.
4/ غير أن الرد على الجابري في أطروحته، جاء على لسان دارسِ الشاطبيّ الأكبر، وهو الدكتور أحمد الريسوني في كتابه المرجعي “نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي”، فقد انتقد الجابريَّ نقذا لاذعا، (ومعه “عبد المجيد تركي”)، وزيّف دعوى القطيعة، وأبان بالضدّ من ذلك؛ مديونيّة الشاطبي لكل الأصوليين قبله، بل مديونيته للمذهب المالكي أيضا (إذ هو مذهب الاستصلاح والاستحسان). وأبطل الربط الذي أقامه الجابري بين الشاطبي وابن رشد (تأكيدا لبرهانية الشاطبي)، ليجعلهُ بين الشاطبي والغزالي، “حتى ليمكن اعتبار الغزالي أحد أبرز شيوخ الشاطبي رغم القرون الثلاثة التي تفصل بينهما” (نظرية المقاصد ص310). ويختم الريسوني نقده للجابري بقوله: “هكذا بكل راحة بال، يستسهل باحث كبير ومفكر شهير الجزم بأن فكرة المقاصد أخذها الشاطبي عن ابن رشد، ولا استدراك ولا احتمال! ولا إثبات ولا استدلال!” (نظرية المقاصد ص317).
5/ ولا شك أن دعوى عريضة كالتي طرحها الجابريُّ، لم تكن لِتفوتَ ناقدَ الجابري الأشهر والعنيد، وهو جورج طرابيشي في مشروعه العظيم “نقد نقد العقل العربي”، ففي الجزء الثالث منه “وحدة العقل الإسلامي”، خصص طرابيشي فصلا لنقض أطروحة الجابري بعنوان مستفز “الشاطبي: شافعي عصر الاندثار” (ص315)، حيث عمل على تسفيهِ ما سمّاهُ بالتضخيم الإبستمولوجي للشاطبي، الذي يقرأ خطابا ينتمي إلى العصر الوسيط بمفردات فلسفة العلم الحديثة، “والتحليق بالشاطبي لإسقاطه في الفضاء العقلي للقرن العشرين” (وحدة ص318). والحال أنّ الشاطبيَّ حسب طرابيشي لم يقم بأكثر من ترتيبِ مادّة المقاصد كما وردت عند الأصوليين قبله، بهدف إعادة بناء علم أصول الفقه مُستنسِخا مشروع الشافعي، “فليس كمثله (أي الشاطبي) من صبا إلى أن يكون للأزمنة المتأخرة ما كانه الشافعي للأزمنة المتقدمة” (وحدة ص319) ولقد عمل طرابيشي على تفكيك دعاوى الجابري واحدة واحدة، فإذا كان الأخير حاول الربط بين مشروع الشاطبي و”المشروع العقلاني” لكل من ابن حزم وابن رشد (المدرسة المغربية). فقد أكد طرابيشي أن “العكس هو الصحيح، فلم يقطع الشاطبيُّ مع أحدٍ كما قطع مع ابن حزم وابن رشد” (وحدة ص321). بل إن ابن حزم وإن كان النقيضَ الموضوعي للشاطبي، فإنه تجمعُهُ به على الأقل “علاقة تضاد”، أما ابن رشد فما يجمعُهُ بالشاطبي هو “محض لا علاقة”، كما يؤكد طرابيشي، فلم يكن حاضرا بأي شكل من الأشكال في مشروع الشاطبي ولا خطر على باله (وحدة ص330).
وبعد مُرافعةٍ طويلةٍ عريضة، خاضها طرابيشي مستعملا جميع أنواع الأسلحة، ومُستحضرا خصوم الجابري كافة، ينتهي إلى أهمّ نتيجة، تقلبُ أطروحة الجابري رأسا على عقب. وهي أن مشروع الشاطبي لا يُعتبَرُ “بحال تجييرا للبيان نحو جنة البرهان” كما يزعم الجابري، بل “زحزحة للبيان نحو قارة العرفان”، يقول: والحقيقة أنه لو كان لنا أن نُزيحَ الشّاطبي عن موقعهِ المشروع والثابت في عالم البيان، فأحرى أن نزيحَهُ لا نحو عالم البرهان، بل نحو ذلك النقيض المطلق للبرهان، الذي هو في نظر ناقدِ العقل العربي، العرفان” (وحدة، ص 372).
6/ هذا الاستنتاجُ الأخير الذي انتهى إليه طرابيشي (أي عرفانية الشاطبي بدل برهانيته) يضعنا وجها لوجه أمام ردٍّ تعمّدنا تأخيرَهُ، لأنه يرتبط بالكتابِ مشروع هذه القراءة. أعني ردّ الفيلسوف البارز طه عبد الرحمان، وذلك في كتابه “تجديد المنهج في تقويم التراث”، الذي خصّص فصولا منه لنقضِ قراءةِ الجابري “التفاضلية” للتراث الإسلامي، في مشروعه “نقد العقل العربي”. مُقترحا في الفصُول المُتبقيّة معالمَ قراءةٍ “تكاملية” للتراث العربي الإسلامي. ففي سياقِ تدليلهِ على مظاهر “التداخل الداخلي والخارجي بين العلوم الإسلامية”، (وهو التداخلُ الذي يبرهنُ على نظريّتهِ في التكامل)، خصّص “طه” الفصل الثاني من الباب الثاني للحديث عن “التداخل المعرفي الداخلي” (أي التداخل بين العلوم الإسلامية الأصيلة)، واختار نموذج الشاطبي، للتدليل على التداخل بين “علم أصول الفقه” و”علم الأخلاق الإسلامي” (أي التصوف وإن كان طه يتجنب استعماله لحمولته التاريخية القلقة) (تجديد ص97).
هنا تكمُنُ جوهرُ أطروحة طه عبد الرحمان، التي تقلبُ أطروحة الجابري جذريّا، فالشاطبيُّ بالنسبة إليه، لم يرتفع بالبيان إلى مرتبة البرهان، عبر تأسيسه للقطعيات العقلية في مقاصد الشريعة، بل إنّ المقاصدَ لها دلالات أخلاقيّة، تنضحُ بالأحكام القيمية، ومن ثم فالشاطبيُّ ارتفع بالبيان إلى مرتبة العرفان (التصوف)، هذا الارتفاع هو سقوط في نظر الجابري، مادام يَعتبرُ أنّ العقل العرفاني هو أحط هذه العقول وأضعفها. أما “طه” فحسب تقسيمِهِ الثلاثي لمستويات التعقل: العقل المجرد (البرهان) والعقل المُسدّد (البيان) والعقل المؤيد (العرفان)، فهو يجعل العقلَ العرفانيّ أعلى العقول، والعقلَ البرهاني أضعف العقول. ومن ثم فإن مزج الشاطبي لعلم أصول الفقه بعلم الأخلاق (وهو ما أثمر نظرية المقاصد)، يعني عند “طه” تأسيس البيان على العرفان (التصوف) وليس على البرهان كما يزعم الجابري. وعلى هذا يكون “علمُ المقاصد هو الصورة التي اتخذها علم الأخلاق للاندماج في علم الأصول” (تجديد ص103).
هذا هو السّياقُ الخارجيُّ لأطروحةِ “طه عبد الرحمان” الجديدة، إذ لا يمكنُ فهمُ الكثير من الأفكار الواردة في الكتاب، دون معرفة طبيعة الصّراع الذي خاضه “طه” مع مختلف التوجهات العلمانيّة، سواء في العالم العربي، كما يظهرُ في بعض كتبه (“تجديد المنهج” و”روح الحداثة” مثلا)، أو على مستوى الفلسفة الغربية، التي خصص لها كتابين من أهم كتبه، وهما “بؤس الدهرانية” و”شرود ما بعد الدهرانية”. وقبلهما “سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية”. أما السّياق الداخلي للكتاب، فهو جزء من نظرية نسقيّة شاملة، انشغل “طه” بتطويرها وترسيخ صواها وأعمدتها ومدّها بما تحتاجه من مفاهيم إجرائية، وأدلة عقلية، تجمع بين حرارة الإيمان وصلابة البناء المنطقي وتماسكه، وهي النظرية الائتمانية.. التي بسطها في كتابه “روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية”، وبصفة خاصة في كتابه الأخير (المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانيّة)، كما قدم لها تلخيصا مفيدا في مدخل كتابه “بؤس الدهرانية”..
7/ إذن ينخرطُ كتابُ طه عبد الرحمان “التأسيس الائتماني لعلم المقاصد”، في مشروع “النظرية الائتمانيّة” الطهائية، وهي نظريّةٌ إيمانيّة تقفُ على طرف النقيض مع أنماط “الدُّنيانيّة” التي تجتهد في فصل الدين عن الدولة (العَلمانية) أو فصل الدين عن العلم (العِلمانية)، انتهاء بفصل الدين عن الأخلاق (الدهرانية)، بل المروق من الدين كُليّةً (ما بعد الدهرانية). وقد خصّص لكل نوع من أنواع هذه الفصول (من الفصل) كتابا مستقلا. وكأنه يقطعُ الطّريق أمام بعض الدعوات الحداثية، التي تذرّعت بالمقاصد لإلغاء التشريع الديني، وتجاوز أحكام الفقه جُملة. بيد أن “طه” غير معنيّ بالحديث عن المقاصد من جهة دلالتها على الأحكام (الاجتهاد المقاصدي)، بل إنه معنيٌّ بالتأسيس للفكر المقاصدي قبليّا، ويقصِدُ بالتأسيس: المبادئ الكبرى التي تقومُ عليها فكرةُ المقاصد ذاتها، وكأننا أمام ضربٍ من “فلسفة المقاصد” أو فكر “ما قبل المقاصد”. وهو ما يوضّحهُ في مدخلِ الكتاب، الذي يقدّمُ مفتاحا منهجيّا لا محيدَ عنه لفهم الكتاب.
التأسيسُ لعلم المقاصد يُجِيبُ عن سُؤال المشروعيّة. أي ما الذي يَجعلُ من القول بالمقاصد قولا ممكنا ومشروعا؟ ومن ثم يُميّزُ “طه” بين “التقصيد” الذي يبحث في “شرعية الحكم”، وبين “التأسيس” الذي يبحث في مشروعية الحكم (ص14) ويرى “طه” أن سؤال المشروعية كان غائبا عن الفكر المقاصدي، فعلى الرغم من أن الشاطبي اجتهد في بيان “حاكميّة المقاصد”، إلا أنه “لم يتطرق قط إلى المشروعيّة التي تستوجبها هذه الحاكمية” (ص19). والسبب في هذا الغياب حسب “طه”، يعود إلى انشغال الفكر المقاصدي بالبلاغ النبوي (من جهة دلالته على الأحكام). غافلا عن “الخطاب الإلهي” السّابق لهذا البلاغ، “إذ خاطب الإلهُ الإنسان بغير طريق التبليغ، وأخذ عليه عهودا مصيريّة، مرتضيا إياه بموجبها، شاهدا بربوبيته وحافظا لأماناته” (ص21).
وإذا كانت أركانُ حاكميّة الفقيه المقاصدي هي “الفطرة” و”الإرادة” و”التزكية”، فإن التأسيس الائتماني لهذه الأركان يستوجبُ ربطها بالمواثيق التي أخذها الله من الإنسان (على مستوى الخطاب الإلهي)، وهي “ميثاق الإشهاد” الذي يقابل مبدأ “الفطرة”، و”ميثاق الاستئمان” (= عرض الأمانة) الذي يقابل “الإرادة”، و”ميثاق الإرسال” الذي يقابل “التزكية”. هذه المواثيقُ تلخص جوهر “النظريّة الائتمانيّة” لطه عبد الرحمان، بناء على التقسيم الثلاثي السّابق، جاءت أبواب الكتاب الثلاثة، ليختصّ كلُّ بابٍ بمستوى من مستويات التأسيس: (الباب الأول: تأسيس الفطرة على ميثاق الإشهاد) ـ (الباب الثاني: تأسيس الإرادة على ميثاق الاستئمان) ـ (الباب الثالث: تأسيس التزكية على ميثاق الإرسال).
يتبع